تقديم
في مطلع القرن التاسع عشر عرفت كوبا ظهور شاعرين كبيرين، تجمعهما أواصر الدم والقربى، وسَيكونُ لهما تأثير عظيم في الحياة الأدبية لا في الجزيرة وحسب، وإنما في العالم كلّه: خوسي ماريا إي هيريديا (José María Heredia) (1803-1839) أحد أبرز شعراء الرومانسية، لدرجة أن مؤرخي الأدب في أميركا اللاتينية يعتبرونه أهمّ شاعر في أميركا. فهو يقول عن نفسه في مذكراته: "وعرفت بشاعر نياغرا، وعدّوني المترجم الأول للطبيعة الأميركية، وأرفع شاعر مدني، والرومانسي الأول في أميركا، بل لقد وصفوني بالمؤسس لإحساس مختلف عن الإحساس الاسباني"[1]. لم يعش هيريديا حياة طويلة، ذلك أنه توفي في سن الخامسة والثلاثين، لكنه كابد المرارة والألم بسبب مواقفه السياسية المناصرة لاستقلال كوبا، وتعرّض للنفي وعاش بعيدا عن الوطن الذي ما فتئ يبث في شعره الحنين الجارف، والرغبة العميقة في العودة إليه. ولأن حياة هيريديا طبعها الألم والمعاناة من جهة، والحضور الشعري القوي من جهة أخرى، فقد شكلت سيرته الإبداعية والفكرية مصدرًا إلهاميًا للروائي الكوبي ليوناردو بادورا Leonardo Padura الذي كرّس له عملًا روائيًا ملحميًا حمل عنوان: "رواية حياتي"، وترجم إلى أزيد من خمس وعشرين لغة بما في ذلك الكورية والإنكليزية واليابانية والفرنسية والعربية التي صدر فيها بترجمة بسّام البزّاز عن دار المدى (2019).
أما الشاعر الآخر فهو خوسي ماريا دي هيريديا (José María de Heredi) (1842-1905) من أب إسباني وأم فرنسية، هاجر إلى فرنسا مع والدته وصار شاعرًا فرنسيا مكرّسًا حتى قبل أن يتحصّل على الجنسية الفرنسية عام 1893، وينتخب لاحقًا عضوًا في الأكاديمية الفرنسية عام 1894. يعرف هيريديا الفرنسي بأنه من أبرز رواد المدرسة البرناسية التي تمثّل مشروعها الجمالي في الاهتمام بالشكل، والبحث عن الكمال الفنّي، وهي السّمة التي رأى النقاد أنها تميز شعرية هيريديا كما في عمله "تذكارات النّصر" Les trophées الذي صدر في باريس عن دار Lemerre عام 1893. ومن أشهر قصائده، أنشودة "الفاتحون" Les conquérants التي تناول فيها رحلة كريستوفر كولومبس إلى السّيبانغو (اليابان) التي انتهت باكتشاف أميركا، وهذه الأنشودة تحتلّ موقعًا رفيعًا في كلّ المختارات الشعرية الفرنسية[2].
في هذه المقالة التي نَصدرُ فيها عن تصور للأدب مفاده أن كلّ عمل فنّي ما هو إلا قراءة معينة للعالم، نُحاولُ أن نقارب هذا النص الرّوائي الذي يمتزج فيه التاريخ بالأدب، والتخييل السيرذاتي بالرواية، والصداقة بالخيانة، والحبّ بالكراهية، والمنفى بالحنين إلى الوطن.
سنقدّم في المحور الأول وصفًا مركزًا للعالم الروائي الذي يبنيه بادورا، والجغرافيا التي تتحرّك فيها شخصياته المتخيلة في مسعى لوضع القارئ في سياق القصّة التي يرويها، وفي المحور الثاني سنضيء على المرتكزات الجمالية التي يقوم عليها التخييل عند صاحب "الرجل الذي كان يحبّ الكلاب"، والقضايا الذاكرية والإنسانية والأخلاقية الأوسع التي يثيرها عمله الروائي الذي يولّد مشاعر خاصّة لدى القارئ تتعدّى حدود الثقافة أو الجغرافيا التي ينتمي إليها. وهذه إحدى سمات الأعمال الأدبية القوية التي يتعيّن من خلالها الأدب بوصفه ميدان تواصل حقيقي، وبالتالي لا يقوى على وضع ما يرويه أو يعرضه موضع مسافة إلا القارئ الذي يمتلك ثقافة واسعة، وقدرا من التحكم في انفعالاته وعواطفه المشحونة.
رواية تتسع لأكثر من عالم
لنبدأ بالتعريف بكاتب الرواية ليوناردو بادورا المولود في كوبا عام (1955)، وهو من جيل السبعينيات، ويعدّ من الأسماء المعروفة في المشهد الأدبي العالمي. ترجمت رواياته إلى العديد من اللغات، كما يُنظرُ إليه بوصفه الروائي الأشدّ مهارة في خلق شخصيات متخيّلة لها من الفرادة والعمق والقوة ما يجعلها تفرض نفسها على الأجيال القادمة، وتغطي حتى على الكاتب الذي يعود إليه فضل وجودها، مثل ماريو كوند Mario Conde بطل الثلاثية الشهيرة "الفصول الأربعة"، والذي تنطوي تحقيقاته على صورة دقيقة للمجتمع الكوبي. يقول بادورا: "عندما ابتكرت شخصية ماريو كوند في عام 1989، لم أستطع أن أتخيل أنه سيلاحقني حتى اليوم. لعله مثل الزّومبي، لا يموت أبدًا ويولد من جديد باستمرار"[3]. إن شأن بادورا مع بطله ماري كوند، هو شأن الشاعر البرتغالي فيرناندو بيسوا (Fernando Pessoa) الذي ابتكر عددا من الأنداد الذين تمتعوا بالاعتراف الكامل في التاريخ الأدبي مثل ألبيرتو كاييرو، وريكاردو رييس، وألفارو دي كامويس.
كتب بادورا العديد من الروايات منها، بالإضافة إلى الثلاثية، "الرجل الذي كان يحبّ الكلاب"، وهي رواية تدور أحداثها حول واقعة اغتيال تروتسكي، و"رواية حياتي" عن الشاعر الكوبي خوسيه ماريا هيريديا، و"مثل غبار في الهواء"، وأنطولوجيا شخصية تضمّ مختارات من كتاباته القصصية، فضلا عن كتب تناول فيها مفهومه عن الكتابة وعلاقته بكوبا وبالمدن والأمكنة المختلفة التي زارها. يروي بادورا أنه كان في مرحلة الطفولة مفتونًا برياضة البيسبول، وبسببها اكتسب الرّوح التنافسية التي لولاها لما صار كاتبًا. أما أول رواية كتبها فهي Fièvre de cheval التي تنتمي إلى الرواية التعليمية. ويدين بادورا بولوجه عالم الأدب إلى الصّحافة، خاصّة عندما تم فصله من مجلة ثقافية بسبب "الانحراف الأيديولوجي"، وتم إلحاقه بصحيفة يومية لكنّ ذلك كان بمثابة الشرارة التي ستقدح زناد نبوغه الأدبي. يقول الكاتب في الحوار الذي أجرته معه صحيفة LE TEMPS: "أثبتت التجربة أنها حاسمة، ذلك أنني، ويا للمفارقة، تمكنت من القيام بعمل حقيقي كصحافي. استطعت، وكانت هذه أهم نقطة، أن أتعرّف على التاريخ غير الرّسمي لكوبا، من خلال التحقيقات والاتصال بالشخصيات الفاعلة في هذا التاريخ، والسّفر إلى الأماكن الرئيسة التي كانت مسرحا لهذه الأحداث. وتمكنت من كتابة تقارير طويلة باستخدام تقنيات السرد الأدبي. هذه التجربة جعلتني أترك الصحيفة لأكرس نفسي لكتابة الرواية البوليسية"[4].
عندما تضعنا الرواية في قلب الحياة
تتكون "رواية حياتي" من قسمين: يحمل الأول عنوان: البحر ورحلات العودة، والثاني: المنافي ورحلات العودة. على امتداد هذين القسمين، تسرد وقائع سيرتين متوازيتين، الأولى لشخصية واقعية يمثلها الشاعر الكوبي خوسي ماريا إي هيريديا الذي يعكس شعره المرور الإنساني عبر مسالك الحياة غير المتوقعة، والسيرة الثانية تتصل بشخصية متخيلة هي فيرناندو تيري، الأستاذ الجامعي الذي يهتمّ بدرس الشاعر هيريديا، ويقتفي أثر العمل النادر الذي تركه الشاعر، في شكل مذكرات كتبها بعنوان: "رواية حياتي"، من أجل أن يقرأها ولد له لم يره اسمه استيبان خونكو، طالبا عدم نشرها إلا بعد انصرام مائة سنة على وفاته.
تمثل مذكرات هيريديا الكتاب الأخير، أو الكلمات الأخيرة التي أصرّ بها أن يودّع الحياة. إن حالته وهو مصاب بالحمّى وتقيأ الدّم مرتين، وسطوة الشعور بأنها النّهاية الذي يسيطر عليه، ومع ذلك يملي على حبيبته المخلصة خاكوبا هذه الكلمات من أجل أن يقرأها ابنه الذي لم يستطع أن يحضنه ولا أن يقبّله، باعتباره خير من يرسل إليه هذا الاعتراف الذي هو فرصة حقيقية كي يتعرّف على الرّجل الذي كان أبوه، وعن رؤيته النقدية للممارسات الاستبدادية في الوطن الأم، وسياسة الإقصاء والتهميش في المنفى، إن حالة هيرديا هاته، تذكرنا بحالة أبي العلاء المعرّي التي تناولها عبد الفتاح كيليطو في كتابه "التخلي عن الأدب". يقول كيليطو: "هي ذي حالة أبي العلاء وقد أشرف على توديع الحياة. قال لذويه: "اكتبوا". رغم ضعفه وهو يواجه الموت أصرّ، لا شكّ باستعجال، على إملاء كتاب. يحتضر وفي نفسه أشياء يودّ أن تسجل وتنقل، خطاب لا بدّ أن يبلغ"[5]. كما تعكس الكلمات الأخيرة لهيريديا ضربًا من الأسلوب المتأخرّ[6] الذي حلله ببراعة الناقد الفلسطيني إدوارد سعيد.
تروى السيرتان بطريقتين متوازيتين لا رابط بينهما، وعلى شكل شذرات تقع على القارئ مهمة البحث عن الخطّ الجامع بينهما، وتندرجان ضمن سياقين تاريخيين مختلفين. تتجذّر قصة هيريديا في القرن التاسع عشر حيث ولد الشاعر الكوبي عام 1803، وتحصّل على شهادة في القانون عام 1823، واضطر لأن يفرّ إلى الولايات المتحدة بعدما أصدرت الديكتاتورية الإسبانية أمرا باعتقاله بسبب نضاله من أجل استقلال كوبا، وكفاحه ضدّ تجارة العبيد. هذه السّردية التي تركز على تكوّن هيريديا، ونضجه الأخلاقي والشعري المبكّر عندما بدأ يدرك ما يتوقعه منه مجتمعه من خدمة سواء بأشعاره أو بساعديه، تمتدّ حتى مطلع القرن العشرين، أي إلى ما يتجاوز سنة وفاته عام 1839 في المكسيك حيث دفن في قبر جماعي، ومن دون أن يحظى بقبر يحمل اسمه، إذ تنفتح الرواية على شخصية ثالثة هي خوسيه دي خسيوس، ابن هريديا الذي كان ماسونيا، وظلّ يستبدّ به التردّد بين أن يبيع مخطوط والده أو لا، ليقرّر في الأخير تسليم الظرف لكارلوس مانويل ثرنودا، الخبير الموقر لمحفل أبناء كوبا في حفل رسمي ملتمسا عدم نشره إلا بعد عام 1939 بحسب وصية جدته لأبيه التي عاش خسيوس وأختاه تحت رعايتها بعد أن توفيت والدتهم خاكوبا يانيت أرملة هريديا عام 1844 وبعد أربعة أيام من وصولها إلى كوبا: "من هذه الليلة، وبمشيئة من أخينا العزيز خوسيه دي خسيوس هيريديا إي يانيت، فإن المحفل الذي يضمنا هو الحارس على مذكرات أخينا النابه الذكر خوسيه ماريا هيريديا إي هيريديا، الذي كان في أسرار الماسونية قبل مائة سنة، تحت العهد بالكفاح حتى الموت من أجل استقلال أميركا"[7].
 |
تروى السيرتان بطريقتين متوازيتين لا رابط بينهما، وعلى شكل شذرات تقع على القارئ مهمة البحث عن الخطّ الجامع بينهما، وتندرجان ضمن سياقين تاريخيين مختلفين |  |
أما القصة الثانية فهي لفرناندو تيري، وأحداثها تدور في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته وتسعينياته. وإذا كانت سيرة هيريديا التي تروى بضمير المتكلّم تتعيّن فيها الذاتية القوية للشاعر كما لو أنها المرآة الصقيلة التي ينعكس عليها وعيه التام بأنه يؤسّس لتاريخ الأدب الكوبي المهمل، ورومانسيته العميقة المؤطرة لعلاقته بذاته وبالعالم الذي يعيش فيه، فإن سيرة فيرناندو تروى بضمير الغائب من منظور سارد عالم بكلّ شيء، وتستفيد من المذكرات واليوميات والشهادة لدرجة أنها تبدو أقرب إلى الشهادة التاريخية على ما عاشته كوبا في النصف الثاني من القرن العشرين من منعطفات سياسية ألقت بظلالها الثقيلة على العديد من المثقفين والمفكرين والمناضلين الذين نشطوا من أجل الحرية والديمقراطية. ورغم الاختلاف بين السيرتين على مستوى السياق الزمني، إذ تدور وقائع السيرة الأولى في القرن التاسع عشر، بينما تغطي أحداث السيرة الثانية القرن العشرين، فإنهما تتقاطعان على مستوى تشخيص الحياة القاسية التي عاشها البطلان، والمنفى الذي كابد كلّ واحد منهما مرارته بطريقته الخاصّة وتبعا للظروف التي حدّدت مساره، كما تلتقيان في التعبير عن الخيانات والمؤامرات التي تعرّضا لها من أقرب الأصدقاء، مما أدى إلى فرارهما خارج الوطن ليعيشا حياة الضياع والوحدة والتشرد، والشعور القاسي بلامكان محدّد يمكن أن ييمّم نحوه النظر أو توجّه إليه الخطوات. من هذه الزاوية، يظهر أن الرواية متجذرة بقوة في الأرض الكوبية، وتشخص التاريخ الحديث لهذه الجزيرة منذ القرن التاسع عشر وصولًا إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وهذا يعنى أن العالم الروائي يغطي مرحلتي الاستعمار الإسباني والاستقلال.
تبتدئ الأحداث في الرواية من لحظة العودة إلى الوطن. يعود فيرناندو عام 1998 إلى هافانا بعد ثماني عشرة سنة من المنفى، بعد أن تلقى اتصالًا من صديقه يخبره بأن خيوطًا تم الكشف عنها من شأنها أن تقود إلى مخطوط السيرة الذاتية النادر لهيريديا الذي كرّس له رسالته الجامعية. وقبل عودة فرناندو، ثمة عودة هيريديا إلى الجزيرة في عام 1837 بعد أن كتب رسالة إلى الحاكم الإسباني يلتمس فيها السماح له بالدخول إلى الوطن لفترة محدّدة للاطمئنان على والدته التي تمرّ بظروف صحية صعبة. ومنح الإذن بزيارة هافانا في أول عودة له منذ نفيه. ومن المعروف أن هذه الرسالة التي رفض أن يكتبها بعد أن أدين بالنفي الدائم، رغم إلحاح أمّه وخاله، مفضلا العيش بعيدا هاربا على أن يعود إلى كوبا مستفيدًا من قرار العفو، سيضطر بعد سنوات إلى كتابتها في تشرين من عام 1836 إلى فرانثسكو إرنانديت موريخون، مفتش التحقيق في قضية "شعاعات بوليفار وشموسه"، وهي الحركة الاستقلالية التي انضمّ إليها هيريديا في "ماتانثاس" من أجل استقلال كوبا. ستترك هذه الرسالة جرحًا عميقًا في نفسية هيريديا بسبب سوء الفهم الذي طاوله من أصدقائه المقربين، ومن خصومه الذين اتهموه بالتواطؤ، وشككوا في نزعته الوطنية. وبقدر ما ستؤجج العودة إلى كوبا مشاعر غامضة لدى كل من هيريديا وفرنانديز، لدرجة أنهما أحيانًا ينتابهما الشعور بالإحباط فيفكّران في الخروج من الجزيرة حتى قبل انتهاء مدة الإقامة، وهنا يشخص بادورا بقوة الأسئلة ذات الصّلة بشخصه التي تتناسل من فكرة أن تكون كاتبًا كوبيًا، وحجم التوقعات التي ينتظرها القراء من العمل، فإن [العودة إلى الوطن] تضعهما في مواجهة مع الماضي الذي لم يكونا قادرين على نسيانه أو غضّ الطرف عن إلحاحه، خاصّة المؤامرة التي تعرّضا لها، وكانت سببًا في خروجهما من كوبا. يبدو هذا الشعور قويًا وحادًا عند فرناندو الذي لا يستطيع الاستمتاع باللقاء بأصدقائه، فهو يستجوب رفاق "شلّة الساخرين" واحدًا واحدًا من أجل معرفة من وشى به.
انطلاقًا من هذه النقطة، يرتدّ السرد إلى البدايات في شكل استرجاعي، مضيئًا على جوانب مختلفة من سيرة هيريديا الذي تميّز مساره بمناصرة الاستقلال والديمقراطية وتحرير العبيد في مطلع القرن التاسع عشر، والأسرة التي نشأ بين أحضانها ممثلة في والده فرانثسكو هيرديا الذي كان عميد القضاة وابتلي بالسل الذي ضيّق عليه، أو والدته ماريا دي لامارتيد التي كانت شديدة القوة، وتسعى للإبقاء عليه تحت سيطرتها، ووصفه للبيت الضيق مثل القفص الذي كانوا يعيشون فيه، أو فيرناندو الأستاذ الجامعي الذي لا تروق أفكاره النظام السياسي الحاكم.
يتركز السرد الاستعادي على كوبا بلدهما الذي أرغما على العيش بعيدًا عنه، وعلى أرض المنفى الأميركي والمكسيكي بالنسبة لهيريدا، والإسباني بالنسبة لفيرناندو. كما يتقصّى السرد أيضًا مسيرة الوعي الوطني الكوبي بدءًا من عصر شاعر كوبا العظيم الذي فيه بدأ يتبلور الوعي بالاستقلال، والظروف التي عرقلت انطلاق الثورة بسبب التواطؤ بين أثرياء كوبا والمحتل الإسباني خوفًا من ثورة العبيد، إلى المرحلة المعاصرة التي لها ظروفها السياسية والاجتماعية التي تلقي بكلّ ثقلها على الإنسان الكوبي. ومن خلال المحكيات الذاتية الثلاث، تقدّم الرواية رحلة في تاريخ كوبا الحديث منذ حكم أول رئيس وهو جيراردو ماتشادو، كما تسلط الضوء على محطات مختلفة سياسية واجتماعية وإنسانية تنعكس في حياة الأبطال الثلاثة والمسارات المؤلمة التي مروا بها، بما في ذلك الشاعر هيريديا.
إذا كانت الشخصيات المتخيلة تنتهي مساراتها بالموت والذبول، والشعور بأنها مثل الملاح التائه، إذ تكتشف في الأخير أنها "شخصيات بنيت وحرّكت ضمن سيناريو رسمته إرادات آخرين، إرادات تقبع على هامش زمان محدد ومكان منزوع المشاعر والأحاسيس"[8]، فإن ما يلفت الانتباه أيضًا في المادة السّيرذاتية التي ترتكز عليها الرواية، هو سيرة مخطوط هيريديا بوصفه قوة فاعلة قائمة بذاتها. تصور الرواية الرحلة التي قطعتها "المذكرات" من المكسيك إلى هافانا، ومن يد إلى يد؛ من خاكوبا يانيت أرملة هريديا التي حملتها إلى هافانا عام 1844 إلى جدة أبنائها من أبيهم، ومن هذه الأخيرة إلى خسيوس، لينتهي المطاف بالمذكرات بإحدى الغرف بالمحفل الماسوني حيث ظلت مخبأة هناك.
 |
ما يلفت الانتباه في المادة السّيرذاتية التي ترتكز عليها الرواية، هو سيرة مخطوط هيريديا بوصفه قوة فاعلة قائمة بذاتها. تصور الرواية الرحلة التي قطعتها "المذكرات" من المكسيك إلى هافانا، ومن يد إلى يد |  |
وإذ تظهر الرواية محاولات التخلّص من المخطوط بحرقه أو إتلافه، أو باختلاق أعمال أدبية وهمية وترسيخها على أساس أنها تمثل البداية الأولى للأدب الكوبي، فإنها تكشف في المقابل عن قدر الكلمة الصادقة الذي هو أقوى دائمًا من أي محاولة للنسيان أو الطمس. عندما عاد هيريديا من هافانا إلى المكسيك عام 1937 اشتدت أزمته الاجتماعية، ولم يعد الراتب الهزيل الذي يتقاضاه يلبي حاجات أسرته، فاضطر إلى بيع كتبه من أجل شراء الحليب لأبنائه، وعندما تدهورت وضعيته الصحية بسبب السل الذي استفحل في داخله، والموت الذي فجعه في ابنته وولده، ووالد زوجته القاضي العجوز يانيت، ورأى أن موته بات وشيكا، قرّر أن يملي مذكراته على زوجته من أجل أن يتركها لابنه الذي لم يره. هل وصلت المذكرات إلى من يهمه الأمر؟ إن ما يهم ها هنا هو الحصار الذي ضربته الديكتاتورية الإسبانية على المخطوط سعيا للتغطية عليه، والظروف الغامضة التي أحاطت برحلته مما يبعث على الشعور بالقلق والمخاوف، وهذا ما لم يقو كريستوبال أكينو على عدم الاكتراث له رغم وصية خسيوس، فأدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بعدما رأى في صورة الشاعر التي كانت معلقة في المحفل الماسوني ونظرته الشابة المشحونة ما يقول بأن المخطوط يتضمّن ما "يتجاوز القصص العائلية والاعترافات الشخصية التي انطمست ربّما مع الوقت".[9]
لا شكّ في أن الترابط بين الذاكرة والنسيان في هذه الرواية، يحملنا على الالتفات إلى موضوعة نحسب أنها من بين ما يثيره النص من أسئلة قلّما توقف عندها تاريخ الأدب، أو تأملها من زاوية نقدية ملائمة، أقصد ها هنا القوة التي تنطوي عليها الكلمة الروائية التي من شدّة كونها تذهب إلى مدى أبعد في تشخيص الوقائع الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وتصوير المظاهر الأشد ارتباطًا بالواقع الإنساني، فإنه ينظر إليها من قبل السّلطة التي تسعى دائمًا لاحتواء الأدب على أنها تشكّل خطرًا على الحياة، الشيء الذي يقتضي التخلّص منها أو من صاحبها. وإذا كانت حالة هيريديا شاعرًا ومبدعًا ومناضلًا تنطوي على أكثر من علامة تنبّه على محاولات نسيانه أو قتله رمزيًا، فإن ثمة أمثلة عديدة في القرن العشرين، مثل حالة سلمان رشدي، تدلل بوضوح على الجدوى التي تنطوي عليها الكلمة، والوزن الذي يمتلكه النثر الروائي مما يجعله معرّضًا للإدانة والشجب عندما تغيب الحرية والديمقراطية أو تسود الشعبوية. وإذا كان الروائي المكسيكي كارلوس فوينتس أشار إلى هذا الأمر بوضوح عندما يقول: "عندما يزعم دعاة المواقف المنغلقة والمتشددة أن متخيل الكاتب هو من الخطورة بحيث يستحق المحو، فإنهم بهذا الفعل يدفعون الناس أينما كانوا لأن يتساءلوا عن ذلك المحتوى الذي يستطيع الأدب أن يعبّر عنه، ويتكشّف بهذه القوة وهذه الخطورة"[10]، فإن الباحث الفرنسي ويليام ماركس خصّص كتابا لكراهية الأدب، يستعرض فيه الإدانة التي تعرّض لها هذا الأخير منذ أفلاطون وصولًا إلى ساركوزي[11].
*ناقد من المغرب.
مراجع:
[1] ليوناردو بادورا: رواية حياتي، ترجمة بسام البزّاز، دار المدى، دمشق 2019. ص281.
[2] Jean-Pierre de Beaumarchais-Daniel Couty-Alain Rey, Dictionnaire des écrivains de langue française, A-L, Editions Larousse, Paris2001, p818.
[4] Leonardo Padura: «J’ai besoin de la réalité cubaine pour écrire, https://urlz.fr/liG2
[5] عبد الفتاح كيليطو: التخلي عن الأدب، دار المتوسط، ميلانو 2022، ص 70-71.
[6] إدوارد سعيد: الأسلوب المتأخر، ترجمة فواز طرابلسي، دار الآداب، بيروت 2003.
[7] رواية حياتي، ص:159.
[8] رواية حياتي، ص:451.
[9] رواية حياتي، ص:269.
[10] Carlos Fuentes, Géographie du roman, trad.C.Zins, Gallimard, Paris 1997, p.217.
[11] William Marx, La haine de la littérature, Editions Minuit, Paris 2015.



![في التخييل السيرذاتي ["رواية حياتي" لليوناردو بادورا مثالًا] في التخييل السيرذاتي ["رواية حياتي" لليوناردو بادورا مثالًا]](/Content/images/lazy.gif)
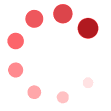 تحميل المقال التالي...
تحميل المقال التالي...