من آخر أعمال أنطونيش، روايتان: "إلى أن تصبح الحجارة أكثر نعومة من الماء" (2019)، و"الباب الأخير قبل الليل" (2022)، وفيهما يتابع رحلته في زيارة الماضي وكوابيسه، كما في قراءة مجتمعه المعاصر.
هنا قراءة لهذين العملين.
(1)
في عام 1979، أي بعد عودته من أنغولا بخمس سنوات، أصدر طبيب برتغالي يُدعى أنطونيو لوبو أنطونيش ـ كان في أواخر الثلاثينات من عمره، (مواليد عام 1942) ـ روايتين دفعة واحدة: أعطاهما عنوانين لافتين: الأولى "مذكرات فيل" (Memória de Elefante)، والثانية "دبر يهوذا" (Os Cus de Judas)، ليعرف معهما نجاحا ساحقًا، ولتبدأ بهما أيضًا حياته الأدبية الفعلية المستمرة لغاية اليوم (بعد أن كان نشر قصائد وهو مراهق شاب، لم يكن لها أي استمرارية في تلك الفترة، بسبب دراسته، كما بسبب خدمته العسكرية). بعدها بسنوات قليلة (1983)، أصدر رواية خامسة بعنوان "فادو ألكسندرينو" (Fado Alexandrino)، ليتأكد حضوره على الساحة الأدبية، بل أكثر من ذلك، أصبح أنطونيش أحد رموز بلاده الفعلية لحقبة ما بعد سالازار. كانت البرتغال، في تلك الفترة، تستيقظ من حقبة الدكتاتورية في أعقاب "ثورة القرنفل"، ومعها يستيقظ جيل أدبي جديد ضمّ أسماء عديدة، من أبرزها: ليديا جورج، جوزيه كاردوسو، جوزيه ساراماغو، وقد شكل مع بعض أسماء الجيل الذي سبقه (ميغيل تورغا، وفيرجيليو فيريرا وغيرهما) نهضة أدبية جديدة، لكتابة تبحث عن أدوات تعبيرها الخاصة، بعد أن بقيت موسومة لفترة طويلة بشعرية فرناندو بيسوا، ونثر "الثائر" (التقليدي في العمق) ميغيل تورغا.
جاءت كتابة أنطونيو لوبو أنطونيش لترمز بشكل حقيقي إلى هذا الذهاب والإياب ما بين الماضي والحاضر، ما بين برتغال سالازار، وبرتغال الحقبة الديمقراطية؛ وما بينهما، ذاك الجرح المفتوح، أو لنقل أيضا الهُوّة التي تفصل بين الحقبتين: حرب أنغولا الاستعمارية، بكلّ ما شكلته من دمار وقتل وسؤال عن معنى الهوية والإنسانية...
(2)
بدا دخول أنطونيش إلى عالم الأدب البرتغالي الحديث دخولًا "كاسرًا"، فرواية "دبر يهوذا"، بدت عنيفة، غير متعزية، غير متوقعة، حول الحرب. جاءت بمثابة توصيف عيادي، مرضي، عن تجربة الكاتب الشخصية الذي كان يومذاك طبيبًا على الجبهة يؤدي خدمته الإلزامية التي استمرت 27 شهرًا ما بين عامي 1971 و1973. كذلك هي تهكم غاضب أتاح للقارئ بأن يفهم، ولو بعد حين، لِمَ أن ثورة القرنفل (1974) ولدت في هذا المستنقع الأنغولي ـ (دبر يهوذا تعني بالبرتغالية "إست العالم" للدلالة على أقذر مكان لأقذر كائن في المسيحية، يهوذا، الذي باع المسيح ببعض الليرات الفضية، واستعارة الكاتب هنا للدلالة على بؤرة الحرب التي كانت قذرة إلى أقصى الدرجات) ـ وكيف كانت ثورة الضباط الشبّان في مواجهة المؤامرات العنيفة؛ وذلك كلّه عبر حبكة بسيطة: حكاية رجل يتحدث إلى امرأة، ذات ليلة، في إحدى حانات لشبونة، وهما يشربان. أتت الرواية على شكل مونولوغ هائل كان الرجل يروي عبره كابوسًا مروّعًا ومدمّرًا: مكوثه كطبيب في أنغولا، في قاع "دبر يهوذا" (في إست العالم)، في هذا الثقب الفاسد، المحاط بحرب قذرة ومنسيّة. جو كابوسي يلف الرواية لولا دعابات صغيرة، عابرة (وإن كانت بدورها رهيبة في العمق): دعابة فشله في علاقاته مع النساء. وكأنه كان يتحدث عن جبهتين، بل عن حربين؛ حرب القتل الاستعماري، وحرب العلاقة مع النساء.
أما "مذكرات فيل" ـ ونلحظ من العنوان اعتماد الكاتب على الذاكرة، فكما يقال إن الفيل من أكثر المخلوقات التي يمكنها أن تتذكر أشخاصًا وأمكنة،... إلخ ـ فتدور أيضًا في لشبونة، عن غرق كائن في حالة من الكآبة والإحباط كما عن "ثورة أخلاقية"، عبر سيرة طبيب يروي كيف يقوم بعملية "طرد شياطينه" المتمثلة بالجراح التي أصابته من خلال علاقة حبّ شديد جعلته يعيش من دون أمل، بشكل يائس، كما وساوس ذكرياته عن الحرب في أنغولا، وتفاقم وعيه بسبب عيشه حياة فارغة وعمله في مؤسسة "يدين عقلانيتها المحمومة". هو اعتراف آخر لرجل كان يبحث من خلاله عن نفسه ـ ومن أجل الكتابة، يعيد اكتشاف فضيلته التي عوضته عن الماضي، أي اكتشافه لتلك الوسيلة العاطفية في الاهتمام بالآخرين.
(3)
اليوم، وبعد أكثر من 24 رواية، وديواني شعر، وخمسة كتب جمع فيها تعليقاته الصحافية، وهي حصيلة ناتجه الأدبي الممتدّ منذ ما يقارب الـ 45 سنة ـ نجد أن ثمة أشياء وثيمات "تتكرر"، من عمل إلى آخر، عند الكاتب. بيد أن هذا التكرار لا يبدو كريهًا البتة، بل هو مستحب، إن لم نقل أساسيًا في عملية بناء عالمه الكتابي الخاص بكونه يخدم فنه الروائي بامتياز؛ من هذه الثيمات المُستعادة الحرب، و"هزيمة الكولونيالية"، خدمته العسكرية بكونه طبيبًا (وفق دراسته)، إلا أنه وجد نفسه يقوم بعمليات جراحية، حيث يصف غالبًا كيف كانت تجري عمليات بتر أعضاء المصابين الجرحى بمنشار يُستعمل عادة لقطع الخشب؛ تَحوّل مدينة لشبونة إلى ما يُشبه حفرة منسيّة في مقاطعة بعيدة، بسبب هجرة أبنائها الدائم لها ناهيك عن الذين لم يعودوا من "أفريقيا" سوى محمّلين في توابيتهم، الأسرة المتشظية، المنهارة، لأسباب كثيرة منها العلاقات غير السوية بين أفرادها، وما تحمله إليها أثقال الحياة ـ الحاضرة والماضية (عبر الذكريات) ـ بالإضافة إلى الكراهية في ما بينهم، وعدم القدرة على إيجاد خطاب مشترك؛ ومنذ سنين بدأنا نجد في رواياته ثيمة المرض، وهو بالتأكيد المرض الذي أصابه وأفقده حاسة السمع، كما الشيخوخة التي تفرض أمراضها على الإنسان. من دون أن ننسى بالطبع، تصريحه الدائم بأن كلّ رواية تصدر له، سوف تكون الرواية الأخيرة، ولن يكتب بعدها، إلا أننا "نتفاجأ" بعد سنتين، أو ثلاثة، برواية جديدة، ذات عدد صفحات أكبر من سابقتها. وكأن الكتابة، ليست فقط دواء شافيًا من العُصابيات المتنوعة، بل كأنها إكسير يجعله يستمر في لعبة الحياة: بمعنى آخر، لن تتوقف الكتابة، إلا عندما يقرر المغادرة، إلى الأبد.
ضمن هذا الجو، وهذه المناخات المستعادة، تأتي روايته "إلى أن تصبح الحجارة أكثر نعومة من الماء" (Até que as pedras se tornem mais leves que a água)، التي صدرت في عام 2019 في البرتغال، لتحمل كلّ هذه الموضوعات التي دأب على تأريخها وأرشفتها إذا جاز التعبير، بذلك الأسلوب القاسي، الفجّ أحيانًا (عند البعض)، لكنه في العمق أسلوب يتناسب مع المناخ العام لعالمه الكتابي.
(4)
منذ البداية، يُعلن صوت امرأة قروية كلّ ما سوف نجده لاحقًا في هذه الصفحات البالغ عددها أقل من ستمئة صفحة بقليل، أي قبل أن تخبرنا أصوات أخرى ما سوف يجري، أو بالأحرى ما سبق أن جرى: لقد قتل ابن عمّها "الزنجي" والده، وهو ملازم ثانٍ لا نعرف اسمه قط، كان من قُدامى المحاربين (البرتغاليين) في أنغولا، وذلك خلال فترة الذهاب إلى موسم الصيد، موسم "اصطياد الخنازير" (من يعرف البرتغال، لا بدّ أن يكون قد شاهد، أو على الأقل سمع، عن تلك الطقوس الخاصة بـ "حفلات الصيد هذه"). اختلطت دماء الأب والابن بالتبني والحيوان في ذلك اليوم في تلك القرية المهجورة. تروي الرواية ما سبق له أن حدث: الحرب التي أنقذ فيها الملازم الثاني الطفل من مذبحة شارك فيها هو بنفسه، الحياة في لشبونة مع الزوجة والابنة التي ولدت بعد عامين من العودة، رحلة إلى القرية من أجل اصطياد الخنزير وجريمة القتل.
كلّ من قرأ أعمال أنطونيو لوبو أنطونيش يعرف كيف تتداخل القصص عنده ببعضها بعضًا، لذا نقع مرة جديدة بين سطور الرواية على هذه القصة المتداخلة، كما على تشابك الحقائق المختلفة، المذكورة، من دون أن ننسى تلك الخاصية البالغة الأهمية في أسلوب أنطونيش: تداخل الأزمنة ـ الحاضر والماضي والمستقبل ـ أي عدم تمييز مجرى الوقت (يقول في أحد الحوارات الصحافية التي أجريت معه أنه أخذ مفهوم الزمن هذا من الثقافة الأفريقية التي لا تميز بين الأوقات المختلفة)، وكأنه نوع واحد من نهر يحمل الكائنات والأشياء، وغالبًا يحملها مع الأفكار المهيمنة، مع لازمة لا تتوقف عن أن تُستعاد: "كم سنة مرّت على ذلك"، "إذا حدث ذلك"، "بينما"، "كثير جدًا"... لوازم يتردد صداها في النص وتكشف عن "روح الدعابة". دعابة حزينة تُنقذ من اليأس الذي يمكن أن يولده السرد. تُسمع أصوات مختلف الأبطال فصلًا تلو الآخر، بدءًا من صوت الأب، الذي حددت كلماته الأولى النغمة: "وفي الليلة الماضية، مثل مرّات عديدة خلال ثلاثة وأربعين عامًا، ما زلت أحلم بأفريقيا". نحن في لشبونة، في "حيّ بلا نعمة"، مع جيران تزعج "ضوضاؤهم النوم الصعب". بعد الأب، سنسمع صوت الابن المُتَبنى، المتزوج من "صاحبة السعادة"، امرأة "محتقرة"، بل مكروهة، نعرف أنها عنصرية، مثل صديقتها التي غالبًا ما تكون معها والتي تتحدث عن "الزنجي القذر".
لا تتكلم الفتاة حتى وقت متأخر من الرواية. ما نعرفه عنها هو أنها لم تحب عائلتها أبدًا، ولم تتحدث أبدًا مع والدها، الذي لا يعرف أين تعيش، وكيف، ومع من وماذا تفعل في هذه الحياة. نسمع كلامها في منتصف الرواية تقريبًا: "أعتقد أنني لا أحب أي شخص على الإطلاق، وما هي هذه المخلوقات التي يمكن أن أحبها، وما هو الهدف من المحبة، والحب من أجل ماذا، والمحبة لكسب ماذا". هذه الفتاة تعود لتحضر لاحقًا في القرية كي تشهد "حدث الطقوس" (طقوس الصيد)، وما تقوله بعد ذلك يكشف عن محنتها العميقة، ووحدتها كامرأة تتشبث بـ "جرعتها" (إدمانها على المخدرات).
زوجة الملازم الثاني هي "الحب". عليك أن تقرأ هذه الكلمة التي تأتي مع الكلمة التي ترددها: "انتباه". إنها لا تريد أن يقترب زوجها منها، ولمسها. بالحديث عن علاقتهما، تقول: "وزوجي هذا يعني نصف السرير، نصف خزانة الملابس، نصف الهواء، نفسًا غير مألوف يذهلني في الظلام، سعال غير متوقع، شبشب ضخم على الأرض، ملابس لا تعرف لمن تنتمي، وهو في الحقيقة ليس بحالة جيدة، إنه وضع منحرف على الكرسي". هي الزوجة المريضة، لذا ربما تكون الحجارة المشار إليها في العنوان هي تلك الحصى التي تسدّ كليتيها. هذا إن لم يكن السرطان الذي ينهشها، والذي يعمل على تدميرها بشكل منهجي. ربما ميل الكاتب إلى الإبهام في تحديد هذا المرض هو ما يجعلنا نقف مترددين أمام تشخيص كنه حالتها بشكل فعلي.
بعد ذلك، تأتي الشخصية الرئيسية: أنغولا. إنها الحرب أولًا، وقبل أيّ شيء آخر؛ هناك شعاراتها المنتصرة: على البرتغال أن تكون "واحدة، غير مجزأة، من مينيو إلى تيمور"، هناك ضبّاط الصف، المتغطرسين، الذين يسيئون إلى الشابات الأنغوليات؛ إنها حياة الكمائن اليومية، والمهمات التي لا تنتهي؛ فقر جيش بلا موارد، إذ تُكلّف أي شاحنة عسكرية من نوع "بيرليت"، أو "مرسيدس"، تكلفة باهظة. هنا نتذكر أيضًا، ما رواه لوبو أنطونيش عن هذه الحرب في رواية "دبر يهوذا"، كما في الكِتاب الذي ضمّ رسائله الموجهة إلى زوجته (بعنوان "رسائل الحرب")، وهي رسائل رائعة تحدثت عن رتابة الأيام الخانقة، والملل، والضعف في هذا الضياع الكبير الذي عرفه في أفريقيا، حيث كانت الحياة بعيدة عنها.
هنا، في هذه الرواية، لا حرف سوى الكسل والعوز واندلاع مفاجئ للعنف. الملازم الثاني كان أحد هؤلاء الرجال الذين اقتحموا القرية وعاثوا فيها قتلًا. لذا تأتي الرواية لتخبرنا عن "حفلات القتل" هذه بكلّ ما تحمله من رعب "الابن الزنجي": "كثير من الناس بلا أيدٍ، آذان كثيرة في الجرار، عدد كبير جدًا من طائرات الهليكوبتر التي تنقل عددًا كبيرًا جدًا من الجرحى، وعددًا كبيرًا من القتلى، كثير من المخيمات التي تلتهمها النيران، رئيس العمليات الذي يتجول حول الأسرى، بكاء مساعد الملازم تحت شاحنة المرسيدس ليتغوط خوفًا من هذه القذارة، قذارته بالدرجة الأولى؛ الابن الذي استقبله الملازم بعد مشاركته في المجزرة، وقتل والدته على الرغم من "ماذا تريد أن تفعل بهذا الطفل؟" و"سينتقم منك عاجلًا أم آجلًا ملازمي الثاني"، وهي الكلمات التي كانت يتوجه بها إليه الضباط المحيطون به".
لا يتحدث الروائي أبدًا عن الحرب. ما نجده فقط تدفق كلمات، وتفاصيل لا حصر لها، والتي تعطي وتقدم في النهاية رؤية ما، لنشعر عبرها بالأحداث ولتكشف ما فعلته الحرب، وكيف دمرت الكائنات، وقطعت الخيوط التي كانت تربطهم بأحبائهم، بحياتهم السابقة. وهكذا، نعرف قصة ذاك الجندي الذي فتح ممرًا بين الأسلاك الشائكة للفرار من المعسكر لكي يذهب إلى الأدغال ويعلن لمن يريد إحضاره أنه "ذاهب إلى الصين". الحرب موجودة حتى في لشبونة، اليوم (لحظة الرواية والتذكر)، في الشقة التي تعيش فيها زوجته والمحارب القديم: "عند عودتي من أفريقيا، كنت أخشى أدنى ضوضاء وأنا أجثو على ركبتي بحثًا عن السلاح الذي لم يعد في حوزتي، ولكني اعتقدت أنه لا يزال لديّ من أجل قتل مزلاج الباب، أو انزعاج الجيران، الرشاشات من كعوب المرأة، البازوكا من خطى الرجل، تنهدات الجرحى، أو الأدراج في الخزانة". الاستعارة تخلط بين الزمان والأماكن، وتبرز ما تجمد إلى الأبد، ضجيج الحرب. ضوضاء نسمعها أيضًا في هذه الزاوية النائية من أفريقيا، مع نباح الضباع والكلاب البرية، تلك المحاكاة للكلاب، أو الذئاب التي تجذبها الجيف.
الحرب هي الغياب كما وصفتها فينينيا، إحدى القرويات، وهي واحدة من الشخصيات القليلة التي تحمل اسمًا في هذه الرواية: "في وقت الحرب، كان لدي خطيب، لكنه لم يعد من أنغولا، وقد فقدت صورته. وأنا الآن لا أفعل شيئًا سوى تذكره". إنه النقص والرغبة الوحشية والجنس المأجور "من أجل تحسين مستوى حنان القوات". لكن عليك أن تسمع كلمات العاهرة "لأن الأمر استغرق مني بعض الوقت لأفهم أن معظم الجنود لا يريدون أداءً، ما يريدون الاستماع إليه هو الدردشة، كأنها مصاصة (طفل)، لكنهم يخجلون من طلبها، لقد سئموا من قتل أنفسهم، لذا هم يأتون كي يجدوننا، إنهم يبحثون عن الانتباه، والعناق، والأصابع التي تضبط ملابسهم، مساحة صامتة لدفن كلّ نفايات الحرب". لا يمكن لأي طبيب، أو اختصاصي نفسي، فهم هذه المعاناة، أو معالجتها.
تحدث الوفاة، المتوقعة، التي أعلنها المتواطئون في الجريمة التي ارتكبت في القرية الأنغولية، والتي أثارها "الابن الزنجي"، الذي كان يحملها دائمًا في داخله. تشبه الجريمة التضحية، بإيماءاتها المحسوبة، التي تتحدث عنها الضحية المستقبلية، وكأنها تستعاد. عرفت الزوجة كيف سيكون الأمر، وكأن العيش بحصوات الكلى جعلها تحصي الأيام حتى النهاية.
(5)
تتابع روايته الثانية، "الباب الأخير قبل الليل/ A Última Porta Antes da Noite" (صدرت في عام 2022)، تلك الحركة التجريبية العائدة لتفتيت الخطاب الروائي، لهذا الشكل الكورالي، الذي تسكنه اللازمة والتضادات، والتكرارات والاستعادات التي تصل إلى حدّ اللامعقول، والتي قام بها أنطونيش منذ روايته "بهاء البرتغال" (O Esplendor de Portugal، الصادرة عام 1997). كما هي الحال في كثير من الأحيان، يبدأ الكاتب من أشياء صغيرة، من حبكة بسيطة جدًا، أو من التفاصيل، أو الملاحظة، أو من العاديات التافهة. إذ أن الكاتب يتغذى على ما يراه ويلاحظه ويتردد عليه. سواء بدأ الأمر بانتحار فتاة مراهقة (ابنة صديق) ليجعلها شخصية رائعة في روايته "لم أرك بالأمس في بابل" (Ontem Não Te Vi Em Babilónia، صدرت عام 2006)، أو خبرًا مرعبًا كي ينطلق منه في كتابة "اسمي فيلق" (O Meu Nome é Legião، 2007)، والذي يتغذى على السياق السياسي كما هي الحال في كتاب "أطروحة عن عواطف الروح" (Tratado das Paixões da Alma، 1990) حول الخلافات العائلية البائسة في "سديم الأرق"، حول المرض في "من أجل تلك التي تجلس في الظلام بانتظاري"، أو في الحروب الاستعمارية المؤلمة العائدة لسبعينيات القرن الماضي في "إلى أن تصبح الحجارة أخف من الماء"، ينسج الكاتب من ذريعة أولية إطارًا سرديًا من التعقيد المدهش والمذهل حقًا.
هنا، خمسة رجال ـ اثنان من محصلي الديون وأخصائي أعشاب ومحام وشقيقه ـ يختطفون رجلًا آخر لينهبوه ويقتلوه ويذيبوه في برميل من الحمض... كانوا على اقتناع بأنهم ارتكبوا الجريمة المثالية ـ "من دون جسد لا توجد جريمة"، مثلما يُذكرون أنفسهم باستمرار ـ لذا نراهم يعودون إلى ملل حياتهم، في انتظار تقاسم أرباح القتل، والتأمل في ماضيهم، وخيبة أملهم، وآلامهم، وخوفهم من أن تعتقلهم الشرطة في نهاية المطاف. استنادًا إلى هذا الإطار الذي يذكرنا بأكثر الروايات "السوداء" (البوليسية) كلاسيكية، يستكشف لوبو أنطونيش تشابك الأرواح الناقصة، كما لو كان ذلك في الوقت الضائع. إنه يتعمق في سيكولوجية الرجال وحدهم، كما لو كانوا على حافة حياتهم، مراقبين عاجزين لإخفاقاتهم، في فراغ وجودهم. إنه يحول قصة خبر قذر وبذيء إلى حدّ ما إلى استكشاف للضمائر المحطمة بالذنب أو الإنكار، ويسعى إلى تحطيم الذكورة السامة التي تقلل من مكانة المرأة وتجعلها مثالية في الوقت نفسه، لتحليل مكان الرغبة والإسقاطات الخيالية، أو صدمات الطفولة التي تمنعك من العيش حقًا.
كلّ شيء في الرواية يبدو معلقًا، وكأنه عالق في إلحاح المشاعر والخوف الذي يُعذّب الشخصيات. ربما هذا هو السبب في أن تسلسلات القصة أقصر ممّا كانت عليه في الروايات الاثنتي عشرة الأخيرة للوبو أنطونيش، حيث انتقلت من حوالي ثلاثين إلى حوالي خمس عشرة صفحة (تمّ إخبارنا أيضًا بوجهة النظر المعتمدة في كلّ فصل من الفصول الخمسة والعشرين، وهو أمر ليس مفيدًا جدًا)، كما لو أن شيئًا ما تسارع فجأة هناك. ذلك لأن حياة هؤلاء الرجال هي حياتهم بقدر ما هي حياة مجتمع مستحيل محطم ومباد. ماضيهم، الذي نكتشف منه تدريجيًا الروابط والأشياء التي لم يتم قولها، يدخل في لعبة من الصدى مع بعضه البعض، لعبة تكرر نفسها دائمًا، وتعود دوما إلى المشاهد المؤلمة ـ عملية اختطاف الفتاة الصغيرة التي تمّ التخلي عنها وتدمير جسدها والأسيد الذي يتدفق في نهر ـ التي تبدو أنها تشير إلى أشياء من وحشيتنا، ما يحيل الرعب إلى ما يمكننا القيام به من دون سبب حقيقي مفهوم.
"الباب الأخير قبل الليل" هي قصة ذنب لا يجد مخرجًا، عن التدمير التدريجي للحاضر الذي يجبرنا على الاستحمام في الماضي، كما لو كان كلّ شيء محكومًا بإعادته، واستئنافه، وتكراره، حتى التكفير. تجتاز الرواية صورًا تجعلنا نشعر بالاضطراب وهي لا تتوقف عن العودة إلى ما لا نهاية ـ رجل يغادر تحت مظلة مع امرأة، فتيات صغيرات في فناء مدرسة ثانوية، طيور ليلية تعبر السماء المظلمة، القمر الذي يأكل العالم، القطارات التي تمرّ في الظلام، أو السيارات التي تدور على طرق لا تقود إلى أي مكان ـ والذي يقول فقط إننا لا نخرج من الماضي، وإن كل شيء يعود إلى الطفولة، إلى ما هو مفقود بشكل لا يمكن تعويضه هناك، إلى ما يقضيه البشر في البحث إلى ما لا نهاية...
سنسمع في هذه الرواية عن الجريمة والخطأ والندم والعودة الأبدية للأصول، إلى المشاهد التأسيسية، ومكانة الرجال والنساء في مخيلتنا، وإبادة الشخصيات التي لا يوجد شيء يمنعها حقًا، هي "نوع" من قُدّاس مظلم حزين جدًا. ولكن، قبل كل شيء، تتيح رواية الجريمة المزيفة هذه (يفكر المرء أحيانًا في تخريب النوع الذي قام به ألان روب غرييه) تجربة أسهل ـ دائمًا ما تكون حسية وفكرية ـ لفضاء وعالم لوبو أنطونيش، لفرك الكتفين بكتاباته، بشكلها السلس بشكل مذهل، ولكن معوق، بجمالها الرائع والخطير، كما لو كانت تعبر الباب الأخير قبل الليل للدخول إلى لغة الغول لأحد الكتاب الهائلين في عصرنا.
(6)
قبل أي شيء آخر، لا يمكننا أن نقرأ أنطونيو لوبو أنطونيش مثلما نقرأ أي كاتب آخر. يتطلب نثره، سواء ذاك المكثف، المضغوط، أو ذاك غير المنظم، إيجاد إيقاع فريد وداخلي وحميم. نحن ننغمس فيه، ونكافح معه، ونتأقلم معه. وفي النهاية، يسكننا. إنه بالضبط ما يلي: لغة الكاتب، بعد أن بدت لنا غير قابلة للاختراق، وشاقة، ولا يمكن الوصول إليها تقريبًا، تدمج نفسها في أذهاننا، وتحوّل مسارها المعتاد. ولا يمكنك التخلص من هذا الشعور النادر في الأدب عن العيش بصوت شخص آخر في داخلك. هناك ويليام فولكنر، بالطبع، جوان غيماريش روزا، أرنو شميدت، خوان بينيت، أو كلود سيمون، الذي قام، مثله، بإنشاء مجموعات، ولغات، ووجد جِرسًا، وأشكالًا تزعج بشكل جذري طريقتنا في القراءة، في النظر إلى النص، في الوجود بداخله بطريقة ما. وعلى مدار أكثر من أربعين عامًا، كان لوبو أنطونيش ينقح، ويعمل، ويزعج طريقتنا في القراءة، والغوص في القصة، وسماع الأصوات. إنه يجعلنا ندرك، في متاهة لغة الكائنات الوهمية، تعقيد وجودنا، وما يزعجهم، ويفككهم دائمًا. في هذه اللغة التي يكتبها نكتشف أشباحنا، وتناقضاتنا، وعيوبنا، وندرك المشكلة التي تكمن في العيش ببساطة. لكن قبل كل شيء نواجه لغة، استخدام لغة ترفض الأحادية ولا يمكن فهمها إلا من خلال تجربة موضوعها، في كثافتها، ومدتها، وفي الوقت المستحيل الذي يلزمها.
قراءة لوبو أنطونيش ليست سهلة. يجب أن نبذل جهدًا، ونقبل ألا نفهم على الفور الخطابات التي تطرح نفسها، وأن يتمّ الخلط بيننا وبين اللغة التي تبدو للوهلة الأولى غير قابلة للاختراق، وغير منظمة، وغير متماسكة تقريبًا. لأن نثر لوبو أنطونيش يفيض، مثل "الزاحف الغازي"، يغطي نفسه، ويتوسع دائمًا. نسمع حاضر النطق، القصص التي تتغذى على الواقع الأكثر شيوعًا، والماضي الذي يتمّ فرضه عليها، ليس في شكل من أشكال التعايش، أو المواجهة، ولكن في الوقت عينه، كما لو أن الوقت قد ألغي إلى حد كبير في كلام نص. وهكذا يكتب أنطونيو لوبو أنطونيش متواليات سردية طويلة، وأشكالًا لفظية متواصلة نحويًا، تتقاطع مع الحوارات والجمل والكلمات والأقواس، والتي تتداخل في مساره، وتتخللها وتعدلها بشكل دائم. وهنا تكمن عبقرية الكاتب الصعبة: بهذه الطريقة لإلغاء حديثه بإطالة أمده، في تحويل إطالة القصة المستمرة المقفلة، التي يضيع فيها المرء، إلى سلسلة من الخطابات الموزعة في ما بينها. ثمة متكلمون مختلفون، يصعب تحديدهم أحيانًا، بل وأكثر من ذلك يصعب تحديد طريق كتابتهم في فترات زمنية مختلفة.
تحقق لغته معجزة التعبير، في الوقت عينه، عن انزعاج الوجود في العالم، وإخبار العالم، وإخباره بحياته، والتكهن بمشاعره، وكثرة الأصداء القديمة التي تأتي لتتداخل بين التفكر والفكر الحقيقي، في ما تبقى من الزمن الماضي في سياق الحاضر، في ما يمكن أن تقوله الشخصيات في الروايات عنه. إنها كتابة الزمن، بل الأزمنة المتتالية التي تتحدّ في ما بينها، التي تتداخل، من هنا هي كتابة تعبّر عن مدة الوقت، عما يُستعاد، عمّا يقاوم. من هنا، هي كتابة تتألف بشكل غير عادي ـ مثل الموسيقى أو لوحة قماشية بديهية بشكل مذهل. موسيقى تأخذنا إلى جانب المفهوم السردي، الموهوب، بقدر ما تجعلنا نؤيد هذا التعاطف الفوري. لأن ما يقوله (ويرويه) أنطونيش ـ والذي غالبًا ما يكون بسيطًا جدًا، وحديثًا، ومبتذلًا للأسف، وإنسانيًا عميقًا ـ يبدو معقدًا بسبب صعوبة قول كل شيء في الوقت نفسه، يبدو صعبًا عند إنشاء هذا النثر المتزامن ـ المتفجر والمستمر بشكل متناقض ـ الذي يربك تشكل الجسم (في وحدته الأخيرة)، بشكل غريب، في عقل القارئ. فنحن عندما نتغلب على هذا الانزعاج الناتج عن عدم الفهم الأولي، لا يمكننا أن نظلّ مندهشين إلا عندما يقع كلّ شيء في مكانه من دون أن نفهم كيف، عندما تصبح القصة واضحة، عندما تجد وضوحها غير العادي الذي يستحوذ على تعقيد الكائنات الشبحية التي يبدو أنها تتجول في روايات لوبو أنطونيش. عند ذاك، يبدو الأمر كما لو أن كاتبًا أخبرنا بكلّ شيء عن شخصياته بجعلها مبهمة، كما لو أنه، بإغراقنا في فوضى خطاباتها، يجعل العصور والأصوات والقصص متساوية، فهو يدرك شكلًا من أشكال الكلية. إن الطابع الشاق لنثره وحده يجعل ذلك كله أمرًا ممكنًا. غالبًا ما تكون هذه معجزة، نوعًا من السحر اللفظي، نشوة مؤلمة.
(*) كاتب لبناني.



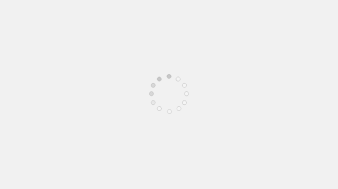
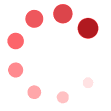 تحميل المقال التالي...
تحميل المقال التالي...