تتماثل مآسي الحروب وتتناسل ظواهرها الوحشية. حتى فرويد وهو يخطّ أفكاره وتأمّلاته عن الحرب العالمية الأولى، يبدو كأنّه يكتب عن حرب غزة الإباديّة اليوم. يلتفت بعبقريته اللمّاعة إلى الفرد الذي ليس نفسه مقاتلًا، وليس بالتالي جزءًا من آلة الحرب العملاقة، يختبر كَدَرًا ذهنيًّا يشعر به البشر غير المقاتلين.
معروفٌ موقف فرويد المناهض للحرب، والمتشائم حيال إمكان توصّل البشرية إلى وقف النزاعات والحروب، مُرْجعًا السبب الجوهريّ إلى الطاقة العدوانية الكامنة في طبيعة الإنسان وتكوينه. يفصّل ذلك في رسالته الجوابيّة إلى ألبرت آينشتاين (راجع مقالتنا "لِمَ الحرب؟" في ضفة ثالثة، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2022) لافتًا إلى أنّ غريزة الموت تتحوّل إلى غريزة تدميرية، ولا فائدة من محاولة التخلّص من نزعات الإنسان العدوانية.
تعود أفكار فرويد هذه في ردّه على سؤال آينشتاين إلى عام 1932، لكنّ تأملات رائد علم النفس والتحليل النفسي في مسألة العنف الإنساني والحرب تعود إلى فترة سابقة متصلة بالحرب العالمية الأولى، يوم وجد نفسه "في دوامة الحرب"، بحسب تعبيره، عاجزًا عن استيعاب الانطباعات المتزاحمة، مكرهًا على الاعتقاد بأنّه لم يسبق أن حدث ما هو أشدّ تدميرًا لكثير من الأشياء ذات القيمة في الثروة المشتركة للإنسانية، مشيرًا إلى أنّ "حتى العلم نفسه فقد حياده، فدفع عالم الأنثروبولوجيا إلى إعلان خصمه دنيئًا ومنحلًّا، وطبيب الدماغ إلى تشخيص مرض العدوّ العقلي أو النفسيّ". ويتحدث عن "التحرّر من الوهم"، وتطلّع الإنسان وسط المعاناة إلى وقف جميع الحروب، بيد أنّ الحروب لا يمكن أن تتوقف، في رأي فرويد، طالما أنّ الأمم ترزح تحت الاختلافات، وتشهد الحياة الفردية درجة عالية من التباينات، وتمثّل العداوات قوة غريزية على درجة مرتفعة من القوة.
يعلن فرويد خيبته من الدول العظمى التي وقعت على عاتقها قيامة الأجناس البشرية، وعُرفت عنها رعايتها المصالح على المستوى العالمي، كما يعود لقدراتها الإبداعية فضل المنجزات التقنية في السيطرة على الطبيعة ومكتسبات العقل الفنية والعلمية. دول وشعوب كهذه كان متوقعًا منها أن تنجح في اكتشاف طريق آخر لتسوية الخلافات ونزاع المصالح في ما بينها، والمشاركة في التطوّر الحضاريّ، على افتراض أنّها اكتسبت فهمًا لمصالحها المشتركة، وقَدْرًا كافيًا من التسامح إزاء الاختلافات التي كانت قائمة بينها. غير أنّ شيئًا من ذلك لم يحصل، فالحروب لا يمكن تجنّبها بين "زملاء الحضارة". تبدّد حتى الأمل الذي أعطاه العصر اليونانيّ يوم أعلن نواب المدن اليونانية أنّ من غير الجائز إزالة أي مدينة في العصبة اليونانية، أو إتلاف زيتونها وكرومها، أو قطع مياهها، فيقتصر النزاع (الحرب) على جانب واحد فروسيّ، مع حصانة كاملة للجرحى الذين ينبغي سحبهم من ميدان القتال، ومثلهم حماية الأطباء والممرضين الذين يكرّسون أنفسهم لمهمة تضميد الجروح، ومع أقصى الإجراءات الاحتياطية للفئات غير المقاتلة من السكان، أي النساء اللاتي يُعفَيْنَ من الأعمال الحربية، والأطفال، مع الحفاظ على سائر الاتفاقيات والتعهدات بين المدن والأمم (فلنتأمل مخالفة الصهاينة المتوحشين لهذه الأعراف الإنسانية كلّها العريقة في الزمن، لجهة تدمير الحجر والزرع والضرع، وعدم تحييد الأطفال والنساء والجرحى، والعودة إلى الأزمنة الأولى للتوحّش البهيميّ خارج كل حضارة معروفة).
| |
| أب وابنه عائدان من أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد في خان يونس لم تبق منه سوى مئذنته المهشمة (16/ 6/ 2024، الأناضول) |
أمّا "التحرّر من الوهم" فرمى به فرويد إلى أنّ الحرب "التي رفضنا أن نصدّق وقوعها" (الحرب العالمية الأولى بكلّ فظاعاتها وشمولها) قد اندلعت، مبدّدةً وهم السلام بين الأمم، ولم تكن أكثر هدرًا للدماء وأشدّ تدميرًا من أيّ حرب سابقة فحسب، بل تطوّرت فيها أسلحة الهجوم والدفاع، واستخفّت بكلّ القيود التي تعرف بـ"القانون الدولي" (ما أشبه اليوم بالأمس) الذي التزمت الدول عهدذاك بمراعاته في زمن السلم، فتجاهلت الجرحى والهيئات الطبية والإسعافية (كأنّنا في مشهد غزة عينه اليوم)، وداست تحت أقدامها بغضب أعمى كل ما صادفت في طريقها (لا عمى يفوق عمى بنيامين نتنياهو وعصابته تدميرًا شاملًا وممنهجًا) مخلّفةً إرثًا من الألم والمرارة من شأنه أن يجعل أيّ "سلام" مستقبليّ مستحيلًا.
تلك الحرب العالمية الأولى جلبت أيضًا إلى دائرة الضوء، بحسب فرويد، حقيقة أنّ واحدة من الأمم العظمى المتحضرة (يقصد ألمانيا بواقعها آنذاك، ويصحّ كلامه على الولايات المتحدة في يومنا هذا) أضحت مكروهةً على نطاق شامل، إلى حدّ استبعادها من الأمم المتحضّرة لكونها "بربرية"، رغم أنّها أثبتت دورها في الحضارة. وبالتالي، ليس أمرًا غريبًا أن يترك ارتخاء الرابط الأخلاقي تأثيرًا مضلّلًا على أخلاقيات الفرد فيرتكب الناس أفعال القسوة والخداع والوحشية التي لا تتواءم مع حضارتهم المفترضة، والتي بدّدتها الدولة بتغييب الأخلاق والقيم وإشاعة "رعب الجماعة"، كما هي الحال في الكيان الصهيونيّ اليوم الذي يغذّي مثل هذا "الرعب" الوجوديّ في المجتمع، ويشجّع جنوده ومواطنيه على ارتكاب أفظع الأعمال الوحشيّة التي قلّما شهدت البشرية مثلها في التاريخين القديم والحديث.
ينفي فرويد إمكان "إزالة" النوازع الشريرة، فالبحث السيكولوجيّ، وبصورة أكثر تحديدًا البحث التحليلي النفسي، يظهر أن الجوهر العميق للطبيعة الإنسانية يقوم على الغرائز الأوّلية، المشتركة بين سائر البشر، والتي تهدف إلى إشباع حاجات أوّلية معينة. تمرّ هذه الغرائز البدائية في عملية نموّ طويلة قبل أن تصبح نشيطة لدى الكائن البالغ. كثير من هذه الغرائز يظهر غالبًا كأزواج من الأضداد، ويسمّى ذلك "التناقض الوجدانيّ"، فيتأرجح الحب والكراهية، مثلًا، في شخص واحد. نادرًا ما يكون الكائن البشري كامل الطيبة، أو كامل السوء، فهو عادةً "طيّب" في شأن ما، و"سيّئ" في شأن آخر، فالذين كانوا في طفولتهم واضحي الأنانية قد يصيرون الأكثر بذلًا للتضحية بين أقرانهم، ومعظم ذوي النزعة العاطفية والإنسانية والمدافعين عن الحيوانات كانوا ساديين ومعذِّبين للحيوانات في عمر اليفاع.
في أزمنة الحروب، ينبغي التمييز بين فئتين، فئة الذين يخاطرون بحياتهم في المعركة، وفئة الذين يقبعون في بيوتهم ينتظرون أعزاء. ولو توقفنا أكثر عند الفئة الثانية التي ننتمي إليها، فإنّ الذهول وشلل الطاقة يتسبّب بهما واقع أننا لا نستطيع الاحتفاظ بموقفنا السابق حيال الموت، فيما لم نكتشف بعد موقفًا جديدًا. قد يساعدنا في ذلك توجيه البحث السيكولوجي نحو علاقتين أخريين مع الموت، الأولى يمكن أن نعزوها إلى الشعوب البدائية (شعوب ما قبل التاريخ)، والثانية تلك التي لا تزال في كلٍّ منّا إنّما متخفّية وغير مدركة بالوعي، بل كامنة في أعمق طبقات عقلنا الدفينة. موقفنا اللا شعوريّ من الموت يكاد يكون هو نفسه موقف الإنسان البدائيّ. يعيش إنسان عصور ما قبل التاريخ داخل لا شعورنا من دون أي تغيير. لا يؤمن اللا شعور فينا بالموت، بل يسلك كما لو كان خالدًا. تتوافق داخله التناقضات، ولا يعي شيئًا عن موته هو، فينشأ عن ذلك أنْ ليس بين الغرائز التي نملكها غريزة مستعدة للاعتقاد بالموت. لعلّه "سرّ البطولة"، فالتفسير العقلاني للبطولة هو أنّها تقوم على القرار الذي يفيد بأنّ الحياة الشخصية ليست أثمن من المثل الأعلى المجرّد، مع الإحساس المرافق ومفاده "إنّ شيئًا لا يمكن أن يصيبني أنا". فيما نعترف بالموت للأعداء ونخصّهم به بالرضى نفسه، ومن غير تفكير، مثلما كان يفعل الإنسان البدائيّ. لا ينفّذ لا شعورنا عملية القتل، بل يرغب فيها فحسب. إننا نُبعد يوميًا وفي كل ساعة كلّ من يقف في طريقنا، وكلّ من أغضبنا، أو أضرّ بنا، وعبارة "ليأخذه الشيطان" التي تنطلق من بين شفاهنا في غضب مازح تعني فعليًّا "ليأخذه الموت". يمكن للا شعورنا أن يقتل، حتى لأسباب تافهة. الرغبات الكامنة فيه تحكم علينا بأن نكون، مثل الإنسان البدائي، عصابة من القتلة.
إن لا شعورنا، في تحديد فرويد، غير قابل لفكرة موتنا الشخصي، إنّما هو ذو عقل إجراميّ تجاه الغريب. ومن السهل فهم تأثير فعل الحرب على هذه الثنائية، فهي تنتزع منا آخر إضافات المدنية، وترمي في العراء الإنسان الأوّل في كلّ منّا. ترغمنا مرة أخرى على أن نكون أبطالًا لا يعتقدون بموتهم، وتدمغ الغريب بأنّه العدو الذي يجب ان نتسبّب في موته، أو نرغب فيه. ولا تزال الحرب في ظلّ الاختلاف الحادّ بين الأمم، ومشاعر الكره بين الشعوب، أمرًا حتميًّا، بحيث يُطرح علينا نحن رافضي الحرب السؤال: أليس حريًّا أن نستسلم ونتكيّف مع دعاة الحرب؟ أليس علينا الاعتراف من موقعنا المتمدّن بمكانة الموت، ونعطي حقيقة الوجود ما لها؟ ألا يجب أن نعيد صوغ المثل القديم "إذا رغبت في السلام، فاستعدّ للحرب" فنجعله على هذا النحو: "إذا أردت احتمال الحياة، فلتكن مستعدًا للموت".
٭ناقد وأستاذ جامعي من لبنان.



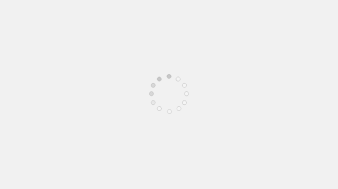
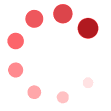 تحميل المقال التالي...
تحميل المقال التالي...