"أغادر هذا الكوكب وأنا متمّم واجباتي تجاه إلهي ديونيسوس، إله الخمر والرغبة والرقص"، "لا تطرق الباب عادة يموتون في هذا الوقت"، "إذا استطعت الانفصال عن القطيع، احذر انضمامك إلى قطيع آخر"- هكذا يكتب عبد الحليم حمود الشعر، وبعد تسع مجموعات شعرية تأتي مجموعته العاشرة على شكل شذرات وشطحات استعار طريقتها من سيوران وبيسوا. يُفلسف حمود الأشياء، يدخل في شرايين المدينة الضيقة، يفكّك المدينة وتفاهاتها في شعره وفي رواياته، ثم يحطّ هادئًا في مرسمه يشكّل المعنى في لوحاته بعد أن يرسم مدينته كاريكاتيرًا على شكل عود ثقاب في ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية. هكذا يتنقّل عبد الحليم من هضبة إلى هضبة حيث يمكنه سماع الأصوات العميقة التي تركها أسلافه تحت جلده. وحمود شاعر وروائي ورسام كاريكاتير وفنان تشكيلي وإعلامي وأستاذ جامعي. تنقّل إعلاميًا بين عدد من القنوات التلفزيونية ورسامًا كاريكاتيريًا بين عدد من الصحف اللبنانية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. أقام عشرة معارض تشكيلية فردية في لبنان، وله ألبوم رسومات كاريكاتير، وأكثر من ثلاثين كتابًا بحثيًا منها في تاريخ الكاريكاتير بالعالم والعالم العربي وترويض الجماهير والدماغ والرأي العام والبروباغندا والسيميائية والصحافة الصفراء وغيرها، وله أكثر من عشرة كتب في السيرة، منها "ناجي العلي"، "زياد الرحباني"، "هتلر"، "غاندي"، "غيفارا"، "مانديلا"، "فريدا كاهلو" وغيرها، وله تسع روايات أولها "دفاتر نوح" (2014) وآخرها "الرسولة" (2023)، وله عشر مجموعات شعرية أولها كوكتيل (1995) وآخرها "كتاب الجمر" (2024).
هنا حوار معه:
(*) تهدي "كتاب الجمر" إلى "أصوات أسلافي المتخثّرة تحت جلدي"، فمن هم أسلافك الذين تدين لهم في تشكيل المادة الخام التي تمتلكها؟
أعتقد أن الإنسان، كما الوجود برمّته، نتاج التوالد العبثي، ولستُ من هؤلاء المنخدعين بشبهات النظام، والنسق، والترتيب. كلّما توغّل الباحث في الفيزياء، وباقي العلوم، سينتبه أننا نتاجات للـ"عشوائية المنظّمة". ضمن قناعتي تلك، هذا يعني أنني وليد الزحف العشوائي لجينات الأجداد التي لهثت لبلوغ هدف زلق، في دهليز مظلم. حصل كل ذلك، وفزتُ بجائزة الوجود الواعي. سأحتفظ بالكأس لبضع سنوات، قبل أن أندثر، فتسترجعه مني الجينات، لتوزع الكؤوس على الأحفاد. كل ما في الأمر أنني انتبهت لمباريات الأسلاف المتعاقبين، فوددت توجيه التحية لهم في "كتاب الجمر"، بما يحتويه من خلاصاتي، وخلاصاتهم التي وصلتني بواسطة الجينات، خاصة أن الكتاب مزيج من أدب حسّي حدسي، وإيغال بحثي في أسئلة الخلق، وفلسفة الوجود. من هنا كان الإهداء: "إلى أصوات أسلافي المُتخثّرة تحت جلدي. يدي الآن تشطر الفراغ، تحزّه بصوّان فؤوسكم"، فكل جهد أبذله في الفن والكتابة، ليس أكثر من مكابدة خاسرة، بيني وبين الفراغ، الرابح دومًا.
(*) وإهداؤك في رواية "الرسولة" صادم، تسمّي 18 شخصًا ولكل شخص تسمّي له مرحلة، من آدم (مرحلة الخطيئة) إلى جوردانو برونو (مرحلة التكفير) ونيتشه وروسو وكافكا وليلى بعلبكي وسنية صالح وصولًا إلى حسين البرغوثي ومرحلة التسكّع... لماذا قدّمت هذه الأسماء وهذه المراحل تحديدًا؟
بعد مغادرتنا بطون الأمهات، جميعنا نتخلّق بفعل الأحداث، أو الكلمات، أو الأمراض، أو المواقف التي ترغمنا على القفز نحو أطوار ثانية، تعيد رسم معالمنا، ونسف بعض مسلّماتنا، وحذف ملحوظ من حبر أنانا، وتعرية الحقائق من هالاتها. في تلك اللحظات الصريحة كالمرآة، يلتقي الإنسان بصورته الأصليّة، التي كانها، أو سيكونها: سرطان في الدم، أو لدغة قاتلة، أو انتحار يائس، أو انتفاض غاضب، أو رقص عابث... أردتُ تحنيط لحظاتهم في صناديق زجاجية، متخفيّة. أن نتأمّل يوسف في بئره. نقرأ فزعه، لا كسوّاح محايدين، بل كشركاء في النوع، نتشابه بحيث نراقب ضعفنا في ضعف الآخرين، قلقنا في قلق الآخرين، تمرّدنا في تمرّد الآخرين...
(*) "كتاب الجمر" يختلف عن الكتب السابقة في أنه يعتمد أسلوب الشذرة، جملة واحدة تعبّر عن معنى عميق، وهو أسلوب نجده لدى سيوران وبيسوا وأنسي الحاج وأدونيس، ما الدلالات التي تقدّمها الشذرة وما الذي يدفعك لكتابتها بديلًا عن قصيدة النثر التي اعتمدتها سابقًا؟
الشذرة فعل تشذيب لا ينتهي. تقليم الوريقات عن حبيبات العنقود. محاولة تعريض الثمرة للشمس الصريحة. يحدث هذا بدقّة الوعي، واعتباطية الكشف، بتلك الثنائية تنضج الشذرة وتتمظهر في كلمات تجريبية، لا يجب أن تتشابه وباقي القوالب المستهلكة. هذا الجديد ليس بالضرورة الأفضل، أو الأجمل، فهو عصارة غير منضبطة فيزيائيًا، بحيث تمتلئ خابية الزيت من حبّة زيتون واحدة، أو احتشاد شجرة زيتون كاملة في قطرة واحدة. قليلة هي القواعد التي تضبط الشذرة، وعميقة هي السراديب التي تصطحبنا فيها الشذرات، لنبلغ أقرب المسافات للشعلة الإشراقية في دواخلنا. أكاد أتصورها مسارًا معاكسًا للانفجار العظيم، بحيث تنحصر الكتلة الضخمة شيئًا فشيئًا، فتعود الشظايا لتحتشد في موادها الأولية، الهيدروجين، والليثيوم، والهيليوم.
(*) تقول إن "الأهم أن نجد إلهًا يؤمن بنا"... هل هو اليأس من عالم متوحش نعيش فيه؟
إن كنّا مشروعًا بحثيًا إلهيًا، فأتخيّل أن النتيجة جيّدة، بل تخطّينا سياج الحظيرة، نحو الفلوات الواسعة. ليس بسيطًا أمرنا بأن اجتهدنا لنبلغ مرحلة الألوهة الفردية. صار لكلّ منّا آراؤه في كل شيء، ولنا قوانيننا، وعزلتنا، وجرأتنا، وأمزجتنا التي تبدأ من تنوع نكهات المثلجات، ولا تنتهي عند حدود الأكوان المتوازية. نشبه قطيعًا من الآلهة. آلهة بأعمار قصيرة، وهذه هي المأساة. في الماضي كان موت الفلّاح فعل استراحة عن تعب سحيق. موت مغمّس برجاء الخلاص، بينما الموت في يومنا هذا، يشبه انطفاء نجم في السماء.
لا أرى أن العالم أكثر توحشًا من ذي قبل. نختزن في دواخلنا أجدادًا من المحاربين الذين أدركوا القاعدة: قاتل أو مقتول. مع مرور الوقت بدأت المصالحات مع باقي البشر، وباقي الكائنات، بتسويات تعاني الهشاشة في أحيان، فلا تلبث أن تندلع الحروب، أو ينفلت وحشنا من عقاله. طفرات لا بد منها في جلجلة الإصلاح والتطور.
(*) تقول: "ينظّر المثقف العربي لفكرة ما بعد الحداثة في مجتمعات لم تدرك الحداثة. وضع يشبه الانتحار قفزًا من الطبقة العاشرة من بناء لم يشيّد بعد"، أنت هنا لا تحكم على المجتمع العربي فقط بعدم الوصول إلى الحداثة كما قال الشاعر شوقي بزيع في كتابه "مسارات الحداثة"، لكنك أيضًا تُلغي وجود بناء عربي، أليس في هذا الكلام هدم لتراث عربي واسع وإن كان عصرنا الحالي يشي بتأخّرنا إلى ما قبل ذلك؟
هي أكبر من أزمة مثقف عربي، نحنا أمام معضلة "العصبة"، "الجماعة"، "القبيلة"، أسرى الهرميّة البطريركية، التي تتحرك بشكل دائري، فيلتصق الرأس بالذيل. حسنًا الحداثة منتج غربي، وما بعد الحداثة كذلك، لكننا لم نبتدع أي جديد يشبهنا، ويلائمنا. حتى تفاسيرنا للقرآن الكريم، أنتجت مذاهب متناقضة من أقصى السلف، إلى أقصى الصوفية، والباطنية. لم نبنِ مشروعًا، ولسنا في مسار تصاعدي بالضرورة، فبينما يحفر الآخرون لبناء أساسات البناء، نحفر نحن لزيادة عدد القبور في بلادنا، من اليمن، إلى ليبيا، سورية، الصومال، العراق... وباقي الأقطار تعاني أزمات في الصناعة، والابتكار، وطرح الأفكار، والإيمان بالأفكار إذا انوجدت.
(*) في كتابك، تشير إلى الأطفال وتقول "يا لفظاعة الفكرة"، ألديك موقف من التناسل البشري؟
هي شذرة على شكل لطمة. شيء يشبه الندب، لرحلة الإنسان، من آلام ظهور الأسنان، حتى مسؤوليات العمل، وبريق التاج، وحلاوة العسل، وصعوبات المرض، وصعقة الموت. حسرة الذوبان في التراب. الأسف على قصر زمن اللعبة، بما لها وعليها.
(*) تميّز بين صنفين من المبدعين: المصابون بنرجسية مضخّمة، وأولئك الذين يُغيّبون أناهم ويتحركون دون هالات فلا نبالي بهم، أين يتحرك عبد الحليم وهو المتهم بنوع من النرجسية؟
نخطئ بتعريف النرجسيّة كمصطلح نفسي له علامات ودلالات، وهي اضطراب واضح فاضح في الشخصية النرجسية. أما عموم الناس، فيعيشون ليهتمّوا بأناهم، طعامًا، ومديحًا، وإنجازًا، واحتفالًا، ولباسًا... هذه فطرتنا، التي يحسن بعضنا إخفاءها، وبعضنا الآخر يضيئها بهالات مصطنعة. بينما هناك الأنا المضيئة بطبيعتها، مثل حال الفنانين، والأدباء، والزعماء، وربما المدراء، وملكات الجمال، والموهوبين بأصواتهم، ورقصاتهم، وتصاميمهم... إلخ. في هذه الحقول تتفاعل الأنا، تتوهّج، تعلن عن نفسها، تجاهر بمكنوناتها وإنجازاتها، وأحلامها، فيلتبس الأمر عند المشخّص، ظانًّا أنها "النرجسيّة"، فمثلًا لو تواريت أنا، كيف تتوارى كتبي، ولوحاتي، وحواراتي الإعلامية؟ كيف أغيب عن توقيع كتبي، وافتتاح معارضي؟ خاصة أنني مكتظ بالأفكار والمشاريع. لقد كتبتها في "كتاب الجمر": "لا تقهر أناك، تتوحَّش، ولا تلجم وحشك، يقهرك". بالنسبة لي، النجاح والإنجاز أمر جلل، يستأهل الإشهار، والإجهار، فذلك الفتى الذي كنته، ترعرع على خطوط التماس في بيروت، ليعيش كل طفولته ومراهقته في الحرب، وليشتغل في ورش البناء، ويرسب في صفوف الدراسة، ويعنَّف من قبل المعلّمات بالضرب، وطرق الرأس بالجدار. نجاحات اليوم، ترميم وتطبيب لكسور غائرة في النفس.
بينما للنرجسي قناعات بأن الآخرين مجبرون على خدمته، دون أن يكون ممتنًا لهم، وهو يعاني من الثقة المفرطة، ويلهث خلف الإطراء حتى دون إنجازات، ومن سماته أنه لا يشعر بآلام الآخرين، ولا يأبه لأحاسيسهم.
(*) تقول: "حين تموت، هناك متسّع من الصمت، فلا تستبقه"، فهل نفهم من هذه الشذرة أن غزارتك في الكتابة هي لمواجهة الصمت والموت الذي يمكن أن يتلبّسنا بفعل تراكم الأسى الذي نعيشه؟
أوافقك على الشق الأول. غزارة بهدف استغلال وقتنا القصير في حيّز الوجود. أعيش في حال تحدٍّ لحظوي مع العملية الإبداعية، التي تتمظهر نثرًا، وبحثًا، ورسمًا، وقولًا، على مدار الأسابيع والأشهر والسنوات، دون عطل، أو إجازات. لكنه فعل ممتع بالنسبة لي، بأن أقطع سيف الوقت الذي يريد بتري، وأنا أعرف أن الضربة الأخيرة ستحسب له. منطق عبثي.
(*) وتقول في روايتك "الرسولة" "أعظم الاختراعات هي نتاج الإحساس بالفراغ، ليس الإحساس به، بل مزاولته كنمط عيش، وها أنا أبتكر طرقي الخاصة لأحسن اللعب معه من داخله للتغلّب عليه"، فهل تملأ فراغاتك بالكتب ولديك عشرات الكتب، وهل الذين لا يُبدعون لا يشعرون بالفراغ، أو لا يعرفون كم أن حياتهم فارغة؟
غالبًا ما أحسد هؤلاء الذين يتنادمون، ويتسامرون في المقاهي، وعلى الشرفات. يشحنون نهاراتهم بالأحداث والحكايات الصغيرة، ثم يفرغونها في نقاشات بلا قواعد، فيتفلسفون، ويتهكمون، ويبوحون، ثم ينصرفون نحو أسرّتهم. في حالة أمثالي، الأمر مختلف، حيث محاولة فهم كل شيء، وتحليل التفاصيل، والانشغال بأسئلة تافهة لا تخطر في بال. هي لذة لا شك، لكن يشوبها ألم الوعي. الأجمل لو ننصهر ونتماهى مع الآخرين، ونشرات الأخبار، والباعة المتجولين، وقطط الشوارع، وضوضاء الأرصفة. في كل هذا الضجيج، تخدير، وصرف انتباه.
(*) تتحرّك في اتجاهات متعدّدة، كان لك عشرة معارض في الفن التشكيلي وفي فن الكاريكاتير السياسي ومؤخرًا كان لك معرض في بيروت بعنوان "غزلان تشطر المعنى"، حدّثني عن معرضك الأخير، وأود أن تحدثنا عن هذا الانتقال فيك بين الأجناس الفنية والأدبية؟
كلّما أدبَرَت نفسي عن فن من الفنون، تقع في مصيدة فنّ آخر، فلا تبتعد عن اللعبة الإبداعية، فأكتب الشذرة، ثم أفرّ نحو الرواية، وأستريح عند اللوحة. اعتدت الرسم لشهر أو شهرين في العام. ثم أنكفئ بعد أن أنجز ما يوازي معرضًا متكاملًا، وأنا ممّن يمزجون التكنولوجيا بالألوان، بحيث أصمّم لوحتي بواسطة الكمبيوتر، وأتابع الاشتغال عليها على القماش، معتمدًا الحروفية العربية، والتنوع المشهدي الحرّ، بشيء من التداعي السوريالي. التشكيل يريحني عقليًا، ويرهقني جسديًا، فأنا أرسم من لحظة الاستيقاظ حتى آخر الليل، مع استراحات الطعام.
(*) لديك جرأة في طرح مواقف دينية "انتقادية"، عرّضتك لخسارات كثيرة، منها أن الرقّ جائز في الإسلام وهناك 20 آية قرآنية تتحدث في جواز العبودية، وأن الأمم الإسلامية انصاعت لاتفاقية إلغاء تجارة الرقيق مرغمة، هل نحن على مسافة بعيدة من نقد الفكر الديني، وبرأيك هل القضية هي قضية نقد الدين أم نقد الفكر الديني؟ وهل ترى أن محاربة النقد الديني سبب في رجعية الشعوب العربية إذا عدنا لمقولات صادق جلال العظم؟
نعيش اليوم طفرة نقدية، والمتابع للمنصات البديلة كاليوتيوب، والتيكتوك، سيعثر على الآلاف من العرب الذين ينتقدون بإيقاعات متعدّدة من حالات الرفض الكلّي، إلى النقد الإصلاحي، وأغلبهم يعيشون في بلدان الاغتراب، حيث أن حياتهم بمأمن نسبي هناك. من ناحيتي كتبت الكثير، وبعض آرائي مدرجة في رواياتي، وأراني منقسمًا بين خطين: الأول إيجابي، يسلك مسارًا إصلاحيًا، ليخرج الدين من تلك الطبقة العالقة في وحول التاريخ، وواحاته، بينما الخط الثاني أكثر راديكالية، فأنتهج الحالة الصدامية للفكر الديني، الذي أحمّله مسؤولية نصف هزائمنا، فالدين بمعناه الوجداني، الطقوسي، أمر شخصي، وربما محمود لمساعدة النفس على تقبّل مصاعب الحياة، ومطبّاتها. المشكلة حين يبدأ المتديّن بفرض أفكاره على المجتمع، وتبنّي آراء جامدة، قاطعة، تجاه المرأة، والزواج المبكر، وسلطة الذكر، وشكل اللباس، وتأطير الفنون، وتحريم الغناء، وتكفير الآخر... هكذا أشعر وكأني في حلبة ملاكمة، ومن واجبي تفادي اللكمات، بل ومحاولة ردّها بمثلها. المثقف ليس حكمًا محايدًا، متفرّجًا. نحن طرف في حروب ظلامية.



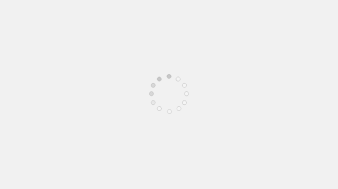
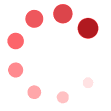 تحميل المقال التالي...
تحميل المقال التالي...