لماذا نستمرُ في قراءة ريموند هنري ويليامز اليوم، وبعد مرور أكثر من ثمانية وعشرين سنة على وفاته؟
في مقالةٍ مُطولةٍ له بعنوان "قراءة ريموند ويليامز اليوم" وهي منشورة ضمن كتاب "الثقافة والمادية"(1)، يتساءل الباحث واللغوي الفرنسي جان- جاك لوسيركل: "لماذا نترجم اليوم نصوصًا لها ثلاثين سنة أو ربما أكثر؟"، ويستطرد قائلا: "العالم الذي عرف وحَلَّلَ ويليامز الذي توفي سنة 1988، هو العالم قبل سقوط جدار برلين، هو القرن العشرين، كان عالم آبائنا وليس عالمنا، إن العالم الفكري لويليامز مقترن بالوضع التاريخي، سنوات الثلاثينيات، الحرب الكبرى ضد النازية، الحرب الباردة، نضالات التحرر من الاستعمار، التنمية العالمية للماركسية وأزمتها، لكن أيضا، بدايات عصر الليبرالية الجديدة مع تاتشر وريغان، كل هذا ليس هو التاريخ القديم، فنخاطر بوضع نصوص مترجمة بأدوات عفا عليها الزمن"(2).
إن ما يدعونا إلى قراءة أو إعادة قراءة ريموند ويليامز هو أثره التاريخي في عالم الأفكار، خاصة أنه يُعَدُّ واحدًا من أهم المنظرين لحقل الدراسات الثقافية، ليس في بريطانيا بلده فحسب، وإنما في سيرورة الفكر الإنساني الكونيّ، وفي تاريخ الماركسية الأوروبية، فضلًا عن أن الحاضر والمستقبل لا يتأسسان إلا عبرَ هذه التركة الفكرية التي خَلَّفَهَا ريموند ويليامز، خاصة على صعيد الدراسات الثقافية وتنظيراته حول مفهوم الثقافة وعلاقتها بالطبقات المجتمعية. وفي هذا السياق، يقترح ويليامز التمييز بين "ثلاثة مستويات للثقافة، حتى في أكثر تعريفاتها عمومية. فهناك الثقافة المعيشة lived لزمان ومكان معينين التي لا يمكن أن يصل إليها سوى أولئك الذين يعيشون في ذلك الزمان والمكان. وهناك الثقافة المدونة recorded لكل نوع، من الفن إلى معظم وقائع الحياة اليومية: ثقافة الحقبة، وهناك - أيضا- ثقافة التراث الانتقائي tradition selective بوصفها العامل الذي يربط الثقافة الحية وثقافات الحقبة"(3)، فالفهم الجيد لمراحل الثقافة، يمكننا من امتلاك آليات قرائية جديدة لإشكاليات كل حقبة، انطلاقًا من قدرتها على تشكيل وتأليف قراءة انتقائية لمجتمع ما. صحيح، أنه لا يمكن قراءة كل إنتاج حقبة زمنية معينة، لكن يمكننا العودة إلى المجلدات المطبوعة والكتب التراثية للتعرف على أنماط العيش الخاصة بكل مجتمع، وإن كان ذلك بمثابة نوع من الإقصاء والتهميش للثقافة غير المكتوبة، فهذا الانتقاء يخدم نظريًا وتطبيقيًا الثقافة المكتوبة، في حين تبدو الثقافة المعيشة، ضيقة ومغيبة، وريموند ويليامز في تقسيمه الثلاثي للثقافة، يسعى إلى تفكيك وتحليل الشيفرات الثقافية، وتكوين نظرية تسعفنا في قراءة مرحلة معينة، وبالتالي فهم طرق تفكير طبقة اجتماعية ما، ووضعها في صلب السيرورة التاريخية، وهنا، يكمن دور المؤسسات البحثية في إلزامية الرجوع إلى التراث، ومساءلته وقراءته في ضوء التحولات الجديدة لكل مجتمع.
إن ريموند ويليامز يرفض هذه الحدود الثقافية، على اعتبار أن الثقافة "كيان واحد لا يتجزأ"، وممارسة لا يمكن فهم وفك شيفراتها إلا من خلال علاقاتها مع أشكال ثقافية أخرى، وإن كان تدريس الثقافة الشعبية في المؤسسات المدرسية والجامعية والمراكز البحثية، أمرًا لافتًا، لكن، "الطريقة التي تدرس بها غير بريئة، فهي نتاج لأنساق ثقافية سائدة تغذي هذا التهميش والإقصاء الذي يطول هذه الثقافة. وتزيد في المقابل من سطوة أشكال أدبية وجمالية بدعوى عظمتها وتلاؤمها مع الحس الوطني والقومي"(4)، بمعنى، أن تحليل الثقافة ينبغي أن يكون شموليًا، وليس ضمن دائرة ضيقة وانتقائية، وهذا ما ذهب إليه الباحث أحمد زكي البدوي حين قال: "الثقافة هي البيئة التي خلقها الإنسان، بما فيها المنتجات المادية وغير المادية التي تنتقل من جيل إلى آخر، فهي بذلك تتضمن الأنماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طريق الرموز والذي يتكوَّنُ في مجتمع معين، من علوم ومعتقدات وفنون وقيم وعادات وغير ذلك"(5). وهذا القول، يتقاطع نظريًا مع تصورات كليفورد غيرتس حول الثقافة بوصفها نسيجًا من العلامات التي تفضي إلى تواصل الذات مع ذاتها ومع الآخر، وهي أيضًا تتضمن أشكالًا متعددة من الهيمنة في الوقت الذي تنزع نحو مقاومة هذه الهيمنة وفضحها، كما أنه لا يمكن إغفال دور الإعلام ووسائل التكنولوجيا الحديثة في توسيع الهوة بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبية.
 |
إن ما يدعونا إلى قراءة أو إعادة قراءة ريموند ويليامز هو أثره التاريخي في عالم الأفكار، خاصة وأنه يُعَدُّ واحدًا من أهم المنظرين لحقل الدراسات الثقافية، ليس في بريطانيا بلده فحسب، وإنما في سيرورة الفكر الإنساني الكونيّ |  |
هذا، ولا يمكننا في سياق الحديث عن ريموند ويليامز إغفال إسهاماته في مجال التنظير للحداثة الواعية وطرائقها في التأسيس للنظريات الثقافية، مؤكدًا "على أن الحداثة ظاهرة تاريخية وثقافية، ومن المحتمل بالتالي ألا يتم الوصول إليها بوسائل نظرية أدبية"(6)، وكتابه "الريف والمدينة" يعتبرُ مرجعًا أساسيًا لفهم تصوراته للحداثة وقيمة الوعي بها في التأسيس لممارسة ثقافية استعادية لمفهوم "المجتمع العضوي"، وتجاوزه للبنية التقليدية مقابل الاحتفاء بإمكانات الذات وقدرتها على تدمير سلطة الواقع. وويليامز في الكثير من مواقفه، ينتقد نظرية الانعكاس الماركسية، ويتجه نحو الإقرار ببنية الشعور الملازمة للإنسان، ذلك أن "الاستقلالية للفكر نابعة من أنه فعل الإنسان الواقعي، في سياق وعيه لواقعه، عبر تحديد تصور لهذا الواقع، لكن أيضا بالسعي لتحويله. لكن لا بد من الانتباه إلى أن الفكر بالأساس يسعى للإجابة على المشكلات التي تنتج في الواقع"(7)، ما يعنيه ويليامز هو ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من أجل إنتاج معرفة، دائمة وأزلية، وليست لحظية نابعة من لحظة ارتداد مع الواقع.
| |
| كتابه "الريف والمدينة" يعتبرُ مرجعًا أساسيًا لفهم تصوراته للحداثة وقيمة الوعي بها في التأسيس لممارسة ثقافية استعادية لمفهوم "المجتمع العضوي" |
بقيت الإشارة أيضًا إلى أثر مدرسة فرانكفورت في النقد الثقافي، على اعتبار أن "نظريتها النقدية شكل من أشكال النظرية الاجتماعية المنفصلة بالتدريج عن الماركسية، وأنها مثلت تيارًا واحدًا فقط من الفكر، في إطار حركة التجديد النقدي العريض للنظريات الماركسية والراديكالية"(8)، ولعل تنظيرات مؤسسيها الكبار: ماكس هوركايمر، وثيودور أدورنو، يورغن هابرماس، فريدريك بولوك، هربرت ماركيوز، تمثل نقلة نوعية في تاريخ النظرية الثقافية، مستفيدةً من الحقل الفلسفي وباقي العلوم الإنسانية بشكل عام، لكن الأهم بالنسبة لهذه المدرسة هو تقويض عمل التيار الفكري البورجوازي، وإعادة الاعتبار إلى البعد الاجتماعي للخطاب، ويبدو من خلال مشروعها الثقافي، أنها حركة تسعى إلى التعدد والاختلاف داخل منظومة فكرية مشتركة، ذلك أن روادها الخمسة يشتغلون داخل نظام فكري معين، لكن لكل واحد من هؤلاء تصوراته ومرجعياته الخاصة، يتم استثمارها في قالب جماعي خدمةً للمشروع، هكذا، حاولت مدرسة فرنكفورت الاستفادة من حقل الرواية مع بروست وكافكا، ومن التحليل النفسي مع فرويد، ثم من الفلسفة الجدلية مع هيجل وكانط وغيرهما، ومشروعها النقدي المعرفي لم يتبلور بشكل كبير إلا في بداية الثلاثينيات، حين هاجر معظم روادها إلى الولايات المتحدة الأميركية خوفًا من التوسع النازي وهروبًا من الفخاخ الأكاديمية، بحيث يعتبر الفصل بين النظرية والممارسة أحد الركائز الأساسية لعمل هذه المدرسة، وعليه، فإننا أمام مدرسة تشتغل وفق رؤى واضحة، رغم الاختلاف في التعاطي مع المشكلات المعرفية لروادها، إلا أن جهودها النظرية تُعد مرجعًا أساسيًا في تفكيك ثنائية السلطة والمجتمع، وفضح وسائل السيطرة داخل المجتمعات الراقية، للوصول إلى مجتمع متحرر فكريا من تقاليد المؤسسة ومن صراع الخطابات.
هوامش:
1-Jean-Jacques Lecercle. lire Raymond williams aujourd’hui. culture et matérialisme. Page 5-23.
2- المرجع نفسه، ص 05.
3- ريموند ويليامز: ضمن مقال تحليل الثقافة، خالدة حامد: غبش المرايا، فصول في الثقافة والنظرية الثقافية، منشورات دار المتوسط، إيطاليا، ط 1، 2016، ص 30-31.
4- إدريس الخضراوي: الأدب موضوعًا للدراسات الثقافية، جذور للنشر والتوزيع، ط 1، 2012، ص 39.
5- أحمد زكي البدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان للنشر، ط 1، م 1، 1982، ص 193.
6- ريموند ويليامز: طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد، ترجمة: فارق عبد القادر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، يونيو 1999، العدد 246، ص 11.
7- سلامة كيلة: الماركسية والفهم المادي – حول الفهم المادي للمادية- منشورات المتوسط، إيطاليا، ط 1، 2015، ص 18.
8- توم بوتومور: مدرسة فرنكفورت، ترجمة: سعد هجرس، دار أويا، ليبيا، ط 2، 2004، ص 09.



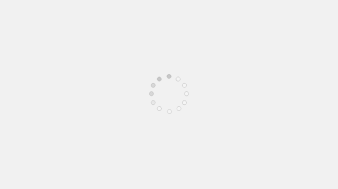
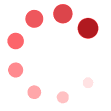 تحميل المقال التالي...
تحميل المقال التالي...